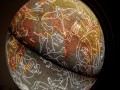الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
السباق المصري مع الزمن
السباق المصري مع الزمن

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
اليوم يكون قد مضت ٦٧ عامًا على ثورة يوليو ١٩٥٢ التى أخذت مصر على طريق «الجمهورية» منشئة حلقة جديدة فى مسيرة الحداثة التى بدأت مع تولى محمد على ولاية مصر عام ١٨٠٥. قرابة قرن ونصف من الملكية وضعت مصر على طريق يعكس ما كانت عليه المحروسة فى عصور سابقة تآكل فيه عدد السكان نتيجة الفقر والأوبئة والمرض والجهل حتى إن مصر التى كانت فى نهاية العصور الفرعونية قد بلغت حوالى عشرة ملايين نسمة (فى مصادر أخرى ثمانية ملايين) أصبحت مع الغزو الفرنسى لمصر عام ١٧٩٨ مليونا ونصف المليون من البشر، نصفهم من الذين يعانون من العمى وأمراض الرمد.
يوم قامت الثورة كان عدد سكان مصر قد بلغ ٢٢ مليون نسمة ويضاف إلى ذلك اختراق كبير للأراضى المصرية من خلال الترع التى أخذت مياه النيل شرقا وغربا، ومن خلال السكك الحديدية التى ربطت أجزاء مصر المعمورة ببعضها، ومع منتصف القرن العشرين كانت مصر فى المرتبة المتوسطة بين دول العالم فكانت أكثر رقيا من تركيا واليونان والبرتغال، وليست بعيدة كثيرا عن إيطاليا. ما كان مهما خلال هذه المرحلة أمران: أولهما أن مصر كانت بنت عصرها تلتقط كل ما أفاء به العلم من التقدم التكنولوجى فى العالم. وثانيهما أنها كانت واعية للسباق العالمى الجارى بين الأمم ومن ثم دخلت السباق وفق مفرداته فى التعليم والصحة والثقافة وأشكال ما بات يسمى بالقوة الناعمة الأخرى من فنون وآداب.
العصر الجمهورى فى عقده الأول حافظ على المقومات الأساسية للدولة الزائلة، واعتمد على النخبة التى تكونت خلال عقد الأربعينيات، وكثيرا منهم كان قد عاد لتوه من البعثات التى جرى إرسالها إلى العالم الأكثر تقدما منها.
... ولكن ذات العصر سرعان مع الستينيات ولأسباب لا مجال هنا للتفصيل فيها أن خرج على المسار الحداثى فى أمرين: أولهما الخروج من السباق العالمى تحت مظلة «الخصوصية» العربية. وثانيهما استيعاب الجماهير تحت مظلة «كمية» من مجانية التعليم إلى مجانية الصحة إلى شبه مجانية الإسكان، تراجع فيها «النوع» الحداثى فى الفكر وتزايد فيها النوع السلفى الذى ظهرت آثاره فيما لحق من أزمان.
هذا المقال ليس مخصصا للمقارنة بين العهدين الملكى والجمهورى؛ ولا يراد منه محاكمة أى من العصرين أو كليهما؛ وإنما التأكيد على أهمية أن تكون مصر جزءا من عصرها، ولديها الإدراك الكامل بطبيعة السباق والمنافسة الجارية فى العالم الذى نعيش فيه. وعندما قام الوالى محمد على بإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا كان لإدراكه أن تقدم المصريين لن يقوم إلا على أكتاف العالم الغربى، وعندما قام إسماعيل ببناء القاهرة الخديوية كان يقيم مدينة عصرية بمعايير أيامه، وعندما سعت الأسرة العلوية إلى بناء جامعة فؤاد كان بداية لجامعات أخرى.
كان انتشار العمران واختراقه الإقليم المصرى من أعمدة المسيرة التى استمرت خلال العهد الجمهورى، وكانت العاصمة (القاهرة) مناط التقدم والإضافة. وفى عام ١٩٥٦ سجل التاريخ إضافة حى «مدينة نصر» وكورنيش النيل وكان كلاهما جزءا من مخطط عمرانى شامل للعاصمة. هذا المخطط بدأ تحديثه مرة أخرى عام ١٩٧٠ ولكن التصديق على التحديث لم يتم سوى فى عام ١٩٧٣، وتضمن تصورًا للمدينة ممتدًا حتى عام ١٩٩٠ تكون القاهرة الكبرى فيها محتوية على ما بين ١٥ و١٦ مليون نسمة، وتمتد شرقًا فى اتجاه مدينة العاشر من رمضان والعبور، وغربًا فى اتجاه مدينة ٦ أكتوبر، وجنوبًا فى اتجاه مدينة ١٥ مايو.
وفى عام ١٩٨٠ أضيف إلى هذا التصور توسعات تشمل حوالى ٩٠٠ ألف نسمة، مع إضافة الطريق الدائرى الذى بات متصورا أن يكون هو المحيط الجديد للعاصمة، والمنفتح على ممرات حضرية فى اتجاه الإسكندرية والسويس والعين السخنة والإسماعيلية والصعيد.
هذا التصور أعيد تعديله وتطويره مرات أخرى فى سنوات ١٩٩١ و١٩٩٤ و١٩٩٧ وفى كل مرة كان الأمر يتطلب إضافة مساحات جديدة لاستيعاب السكان بحيث تستوعب القاهرة الكبرى ١٣ مليونا إضافيا ما لبث أن استوعبتهم العشوائيات.
ما حدث فعلا أيضا هو أنه قبل ثورة يونيو ٢٠١٣ كانت قد اكتملت كليا أو جزئيا ٢٢ مدينة أضيف لها بعدها ١٤ مدينة، بحيث بات متوقعا أن يصل العدد الإجمالى للقاهرة العظمى وحدها ٢٤ مليون نسمة مع حلول عام ٢٠٢٠.
ما كان قصورا فى هذا التوسع العمرانى أولًا أن البنية الأساسية لم تتوفر بنفس سرعة البناء المعمارى، ومن ثم ظلت بعض هذه المدن دون قدرة على استيعاب سكانها؛ وثانيًا أن المواصلات بين هذه المدن والمناطق الحضارية الكبرى سواء كانت فى القاهرة أو الإسكندرية أو مدن القناة ظلت قاصرة عن استيعاب حركة المواطنين؛ وثالثا أنه نتيجة العاملين السابقين فإن الأغلبية من هذه المدن لم يصل السكن فيها إلى الحد المحدد له من حيث عدد السكان فبات عدد سكان مدينة الشيخ زايد ٣٣٠ ألف نسمة، ومدينة العاشر من رمضان ٦٥٠ ألف نسمة وهى أرقام كان يمكن أن تختلف لو تضمنت أعداد العاملين فى هذه المدن؛ ورابعا أن التوسع العمرانى تابعه حالة من عدم الانضباط الاجتماعى التى أدت إلى ظاهرة «الكومباوند» من ناحية، و«العشوائيات» من ناحية أخرى.
هذه السلبيات جميعها تجرى لها المعالجة بأشكال شتى حيث بات التركيز مشتملًا على عدة أمور، أولها الربط بين البناء و«الترفيق» أو مد المرافق الأساسية ومما ساعد على ذلك النهضة الكبيرة فى البنية الأساسية التى انتقلت من العجز إلى الفائض فى الكهرباء والغاز؛ وثانيها أن البناء أيضا أصبح يعاصره مد وسائل المواصلات البرية والسكك الحديدية السريعة و«المونوريل» وساهم فى حدوث أكبر عملية للتوسع فى بناء الطرق جرت فى مصر فى العصر الحديث؛ وثالثها أن تنمية المدن ارتبط بها تنمية مناطقى تحتوى على أنشطة تنموية صناعية أو زراعية أو الصيد والخدمات المختلفة ويجرى ذلك فى محور قناة السويس، والساحل الشمالى، والصعيد، وفى القريب سيناء.
كل هذا الجهد رغم اتساعه فإنه يواجه بالتحديات الكبيرة المصاحبة للزيادة السكانية، والتدهور الجارى فى المدن القديمة والمناطق الحضرية التقليدية، والصعوبات المتصاعدة لإدارة تركيبة معقدة من الحداثة الواجبة فى التعليم والصحة والثقافة والتنمية المستدامة فى وقت واحد.
استخدام الزمن الذى يشكل فارقا فى عملية السباق والمنافسة العالمية نحو التقدم والبناء والعمران.
GMT 17:40 2019 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
لبنان... الانهيار أو الجمهورية الثالثةGMT 10:39 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر
أسباب التضييق على لبنانGMT 10:37 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر
صوت واحد بلهجات كثيرةGMT 10:22 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر
عندما يهبّ «حزب الله» لإنقاذ عهدهGMT 20:25 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو
لم تعد القوات الأميركية قضيةترامب يعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات مع تقديم مرونة لبعض الشركات
واشنطن - لبنان اليوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه سيعلن عن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، مضيفا أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في القطاع. ويعني تعهد الرئيس أن استثناء الهواتف الذ�...المزيدأمينة خليل تكشف كواليس دورها في "لام شمسية" وتبكي تأثراً بكلمات الطفل علي البيلي
القاهرة - لبنان اليوم
حقق مسلسل "لام شمسية" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث حصد المسلسل إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، وتحدثت بطلة العمل الفنانة المصرية أمينة خليل عن كو...المزيدشركة أمازون تظور نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي "نوفا ريل" ليصل الى دقيقتين
واشنطن - لبنان اليوم
قامت شركة أمازون بتحديث نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي، "نوفا ريل"، ليتمكن من إنتاج فيديوهات تصل مدتها إلى دقيقتين.أُعلن عن نموذج "نوفا ريل" في ديسمبر 2024، وكان أول دخول لشركة أمازون في مجال إنتاج الفيد...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©