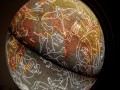الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
جدلية العنف والاقتصاد
جدلية العنف والاقتصاد

آمال موسى
بقلم:د. آمال موسى
صحيح أن الثقافة في مستوى العلاقات الاجتماعية تتحكم في أنماط علاقات الهيمنة بين الأفراد وبين الجنسين، وهذا يمثل معطى ثقافياً تاريخياً مهماً أثبت نجاعته في فهم ظواهر اجتماعية عدة. ولكن من الموضوعية القول أيضاً إن التشريعات في غالبية البلدان عرفت تقدماً وحتى التي لم تقم بالخطوات اللازمة، فإن الضغط الحقوقي الدولي وارتباط الدعم الدولي بالتناغم مع المرجعيات الحقوقية الدوليّة أثرا إلى حد بعيد في دوران العجلة الحقوقية.
المشكل اليوم أن ظواهر اجتماعية بصدد التفاقم والانتشار، ولكننا نفسرها وفق تفسيرات ثقافية لم تعد وحدها مقنعة. ليس بالإمكان اليوم تفسير العنف الزوجي مثلاً بمقاربة الهيمنة الذكورية لا غير، في حين أن هناك أسباباً أخرى جديرة بالتوقف عندها والإنصات إليها.
لقد أصبح العنف في الحقيقة ظاهرة مقلقة ومزعجة ومخيفة اليوم وأكثر من أي وقت مضى. وبشكل حذر، يمكن الاستنتاج أن ارتفاع ظواهر العنف ضد الأطفال والنساء عرفت تزايداً ملحوظاً مع جائحة «كوفيد - 19»، وتواصل الوضع بأكثر حدة مع الحرب الروسية - الأوكرانية، وذلك باعتبار التداعيات الاقتصادية العميقة للجائحة وللحرب معاً.
إذن، مع كل تأزم اقتصادي يرتفع منسوب العنف، وهناك علاقة سببية جدلية بين العنف والتأزم الاقتصادي والعنف والفقر والعنف والبطالة، وهي علاقة استثمرت فيها التنظيمات الجهادية كثيراً وكانت محدداً من محددات تشكيل مخزونها البشري.
إن أحسن مثال يمكن الاستناد إليه لإظهار قوة الارتباط بين الاقتصاد والعنف هو ظاهرة العنف الزوجي. فغالبية حالات العنف بين الجنسين نجدها في العلاقات الزوجية. أي أن العنف الزوجي هو على رأس أنواع العنف بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم. المعطى الثاني أن العنف الزوجي في غالبية الحالات يعود إلى أسباب اقتصادية. ويكثر كلما عرف مجتمع ما أزمة اقتصادية أو لديه مشكلة بطالة. من ذلك، أن الطلاق نفسه يعود في معظم الحالات إلى السبب الاقتصادي؛ الشيء الذي يجعل معدلات الطلاق ترتفع بتعمق الأزمات الاقتصادية والمالية وتدهور المقدرة الشرائية. فالإكراهات الاقتصادية تضغط على العلاقات الاجتماعية وتضعها أمام امتحانات الصمود والتضامن، وهناك من ينجح وهناك من يختار العنف والانفصال.
طبعاً لا يعني هذا أن الطلاق لا يتم إلا بين الذين يعرفون مشاكل اقتصادية، ولا يعني البتة أن العنف الزوجي مقرون فقط بالتأزم الاقتصادي بين الزوجين، بل إن المقصود والجدير أخذه بعين الاعتبار أن التأزمات الاقتصادية وإفلاس المؤسسات وتزايد طوابير العاطلين عن العمل إنما يحوّل العلاقات والبيوت فضاءات للتوتر ومن ثم ممارسة العنف. بل إنّ حتى ضحايا العنف فإن غالبيتهم يعانون هشاشة اقتصادية. فنحن في زمن الهشاشة الأكثر انتشاراً هي الهشاشة الاقتصادية ويمكن تجاوز مظاهر عدة من الهشاشة والتخفيض من حدتها في صورة تتجاوز الهشاشة الاقتصادية. وهنا يتبين لنا أن ضحية العنف والقائم به في حالات عدة هما صنيعة الهشاشة الاقتصادية.
ولا شك في أن هذه المعطيات جديرة ليس فقط بالانتباه إليها، وإنما إلى اعتمادها أساس التخطيط والبرمجة في العالم كله. ذلك أن كل مجتمع صحي وسوي إنما يهدف إلى التعايش والعلاقات الاجتماعية القائمة على التضامن والتقدير والسعادة؛ الشيء الذي يحتم معالجة أسباب العنف الذي يؤدي إلى العنف المادي ويمكن أن يصل إلى مرتبة مأساوية. كما أن حياة الأطفال في أسر مهددة بالحاجة والهشاشة الاقتصادية والعنف بين الزوجين وآثاره المؤلمة على نفسية الأطفال هي في حد ذاتها خسارة في الحاضر والمستقبل للمجتمع؛ لأنه سيدفع تكلفة العنف الحاصل والعنف المستبطن وسيتحمل التداعيات الجميع ضحية العنف والقائم به والأطفال.
إن التعمق في الظواهر الاجتماعية ذات الصلة بالطفولة المهددة والنساء ضحايا العنف يجعلنا على يقين أن المعركة الحقيقية هي اقتصادية، وأن المعالجة تكمن في حل المشاكل الاقتصادية وفي الاهتمام بأبعاد الفقر المتعددة كافة. فاللحظة اقتصادية؛ لأن المشكلات الاجتماعية تتصل بالحلول الاقتصادية، حيث يرتبط الفقر والبطالة بالاستغلال والتسول والحوادث وحتى بالقتل.
لذلك؛ فإن المعادلة يمكن أن تقاس بشكل واضح وبسيط: المزيد من الجهد في القضاء على الفقر والعدالة في التنمية وفي توفير الحق للعمل وضمان الكرامة المادية. وإذا ما تم بذل هذا الجهد كمياً ونوعياً، فإن ذلك يعني آلياً التخفيض من معدلات الطلاق والعنف والجريمة. ولقد علمنا التاريخ أن الاقتصادي والاجتماعي وجهان لعملة واحدة يصرفها الإنسان في كل مكان وزمان.
GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًاGMT 11:46 2025 الأحد ,26 كانون الثاني / يناير
الرئيس السيسى والتعليم!GMT 19:13 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير
أصالة ودريد فى «جوى أورد»!ترامب يعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات مع تقديم مرونة لبعض الشركات
واشنطن - لبنان اليوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه سيعلن عن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، مضيفا أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في القطاع. ويعني تعهد الرئيس أن استثناء الهواتف الذ�...المزيدأمينة خليل تكشف كواليس دورها في "لام شمسية" وتبكي تأثراً بكلمات الطفل علي البيلي
القاهرة - لبنان اليوم
حقق مسلسل "لام شمسية" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث حصد المسلسل إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، وتحدثت بطلة العمل الفنانة المصرية أمينة خليل عن كو...المزيدشركة أمازون تظور نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي "نوفا ريل" ليصل الى دقيقتين
واشنطن - لبنان اليوم
قامت شركة أمازون بتحديث نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي، "نوفا ريل"، ليتمكن من إنتاج فيديوهات تصل مدتها إلى دقيقتين.أُعلن عن نموذج "نوفا ريل" في ديسمبر 2024، وكان أول دخول لشركة أمازون في مجال إنتاج الفيد...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©