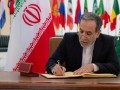الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
لماذا يَخاف إردوغان من بايدن؟
لماذا يَخاف إردوغان من بايدن؟

طوني عيسى
بقلم : طوني عيسى
في البيت الأبيض، تبدأ غداً ولاية غير عادية. وعلى الأرجح، ستشهد السنوات الأربع الآتية تحوُّلاتٍ وانقلابات تُغيِّر معادلاتٍ وخرائط، وسيكون الشرق الأوسط ساحة لها ومادة اختبار. فأي ملامح بدأت بالظهور؟ خلال حملاته الانتخابية، أصرَّ الرئيس دونالد ترامب على التعهّد بأنّ أول أمرٍ سيفعله، بعد فوزه بولاية جديدة، هو إبرام اتفاق جديد مع طهران.
هذه الرسالة وجَّهها ترامب إلى الإيرانيين، ولكن أيضاً إلى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. ليس إلى إسرائيل طبعاً- لأنّ التنسيق معها مضمون في كل الحالات- وإنما إلى الخليجيين العرب.
يبدو الأمر تكراراً لما حدث عام 2017. آنذاك، جاء ترامب إلى البيت الأبيض بعد حملة انتخابية عاصفة، حذَّر فيها إيران من مغبة الاستمرار في خرق اتفاق فيينا 2015، ومن توسيع النفوذ شرقاً. لكنه أيضاً ألمح إلى محاسبة الخليجيين على خلفية معلومات تواردت حول حادثة 11 أيلول.
ولكن، عندما وصل ترامب إلى السلطة، فاجأ الجميع بالمسارعة إلى زيارة الخليج وعقد صفقات بقيمة 450 مليار دولار، دفعة واحدة. وبعد ذلك، كان الدعم الأميركي للخليجيين العرب أمراً محسوماً وأقوى من أي يوم مضى. وفي هذا المناخ، عُقدت اتفاقات تطبيع تاريخية بين الخليجيين وإسرائيل.
يوحي ذلك أنّ ترامب سدَّد ضربة ناجحة. فهو قطف ثمار التنسيق مع العرب و»حمايتهم» من إيران، مقابل وضع حدّ للتعملق الإيراني نووياً وجغرافياً. ولكن، هو يعرف حدود الضغط على إيران ولا يتجاوزها. ويكفي منعها من التمدّد ومحاذاة إسرائيل، من جهة لبنان أو سوريا أو غزة، والحؤول دون وصولها إلى مياه المتوسط وحقول الطاقة وخطوط إمدادها والإطلالة على أوروبا.
سوى ذلك، لم يكن ترامب يريد شيئاً: لا مشكلة في أن يستمر النظام الإسلامي هو الحاكم. ومثله، لا مشكلة في استمرار أنظمة الخليج، أو حتى نظام الأسد في دمشق. وحتى طموحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الشرق الأوسط وعلى حدود أوروبا وشمال إفريقيا، تركها ورقة مساومة للأوروبيين- والفرنسيين خصوصاً- والحلفاء العرب.
بعض المتابعين يعتقد أنّ ترامب، لو فاز بولاية ثانية، كان سيكرّر سيناريو العام 2017: يمارس مزيداً من الضغط على طهران، ليحقق مزيداً من المكاسب مع العرب، سواء في تدعيم موقع واشنطن واستثماراتها، أو في دفعهم إلى الإنخراط مع إسرائيل في مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ويميل عدد من الخبراء إلى الاعتقاد، أنّ هذه القاعدة أثبتت نجاحها في تحقيق الأهداف الأميركية الاستراتيجية. ولذلك، هم يتوقعون أَن لا يقوم الرئيس جو بايدن بتغييرها كمنطلق للعمل، خصوصاً أنّها ترضي الحليف الإسرائيلي وتوفِّر ارتياحاً للحلفاء العرب.
وعلى رغم ما يتردَّد عن تأثير للرئيس باراك أوباما على نائبه السابق، بايدن، في ملفات عدة ومنها الشرق الأوسط، فالمتابعون يعتقدون أنّ الرئيس الجديد لن ينقلب على نهج ترامب الشرق أوسطي، ليس فقط بسبب الأمر الواقع الذي فرضه الرئيس السابق قبل خروجه، بل أيضاً لأنّ هذا النهج أثبت فاعليته في تحقيق الأهداف.
ما تجدر الإشارة إليه، أنّ ترامب لم ينقلب على نهج أوباما الذي يقضي بالحدّ من تورُّط واشنطن بقواها الذاتية في الشرق الأوسط، وجعل مسألة المواجهة مع إيران والقوى الحليفة لها من مسؤولية حلفاء واشنطن مباشرة، لا من مسؤولية قواها العسكرية. وهذا الأمر ظهر خصوصاً في العراق وسوريا. وعلى الأرجح، في هذين البلدين، ستظهر خصوصاً ملامح التغيير الذي سيعتمده بايدن.
يتحدث بعض المطلعين عن اتجاه لدى بايدن لتغيير طريقة التعاطي مع القوتين الفاعلتين في المنطقة: إيران الشيعية وتركيا السنّية. فهو سيكون أكثر استعداداً للعودة إلى الاتفاق النووي، بعد الحصول على ضمانات من طهران بالتزام ضوابطه ووقف عمليات التوسّع شرقاً. وعند هذه النقطة يتوافق الجمهوريون والديموقراطيون.
ولكن، خلافاً لترامب الذي تربطه علاقة شخصية طيّبة بالرئيس التركي إردوغان، سيعمل بايدن على «قصقصة» أجنحة التمدّد التركية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في سوريا والعراق وعبر المتوسط. وهذا الأمر يراهن عليه الأوروبيون أيضاً، ولا سيما منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهو واحد من أسباب انتظار ماكرون لحظة رحيل ترامب.
في نظر بايدن، أنّ تركيا تضطلع بأدوار تؤذي استراتيجية واشنطن، وأنّها تهدّد حلفاءها من داخل الأطلسي، وبالتنسيق مع روسيا التي عمّقت ارتباطها بها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ما أتاح لإردوغان أن يتحدّى الجميع بتهديد خطوط الغاز في المتوسط والتدخل عسكرياً في ليبيا وحسم المعركة في ناغورني كاراباخ، وطبعاً توسيع نطاق النفوذ التركي في سوريا والعراق.
ويقول المطلعون، إنّ بايدن سيمارس نهجاً أكثر حزماً مع إردوغان. وهذا ما بدأ الأتراك يدركونه باكراً ويثير لديهم القلق. وينظر الأتراك بقلق إلى المؤشرات المتعلقة بتركيب فريق بايدن لشؤون الشرق الأوسط. فضمن تعيينات مجلس الأمن القومي، هو سمّى بريت ماكغورك منسّقاً لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسمّى زهرة بيللي رئيسة لمكتب سوريا. وكلاهما معروفان بدعم الأكراد.
ماكغورك واحد من العقول التي شاركت في رسم سياسات واشنطن في سوريا والعراق، على حدّ سواء، خلال عهد الجمهوري جورج بوش الإبن والديموقراطي أوباما. وهو معروف بالتشدّد إزاء تركيا ومطالباته الصريحة بدعم الأكراد وحقِّهم في تقرير المصير. وقد وجّه انتقادات قاسية إلى إدارة ترامب بسبب تراخيها في دعمهم. وأما بيللي، فهي مكلّفة العمل على ملف المصالحة الكردية في شمال شرق سوريا. لكنها لا تسبِّب استفزازاً شديداً لأنقرة بمقدار ما يسبّبه ماكغورك الذي ستزوّده تقاريرها.
لكن الهواجس التركية تُتوِّجها نظرة بايدن شخصياً. فهو في العام 2007، من موقعه في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، اقترح حلّاً في العراق، يقوم على انسحاب أميركي مشروط وتطبيق الفدرالية أو الكونفدرالية. وثمة من يعتقد أنّ فكرته الأساسية كانت التقسيم إلى 3 دول: شيعية في الجنوب، وسنّية في الوسط وكردية في الشمال.
آنذاك، حاول الأميركيون تسويق الخطة لدى أعضاء مجلس الأمن لاعتمادها، ولكن سرعان ما تراجعت الإدارة خوفاً من نفوذ إيران المحتمل في الدولة الموعودة جنوباً. وأما الأتراك فغضبوا من الفكرة، فيما الأكراد لم يتراجعوا عنها.
إذاً، في بداية ولاية الـ4 سنوات، الأرجح أنّ شرقاً أوسط جديداً على وشك الولادة، نتيجة تحوُّلات وانقلابات صاخبة. وستكون ملامحه الأولى بمسار التطبيع ونمو الدور الإسرائيلي، ولكن أيضاً بإعادة ترتيب للأحجام، ولاسيما منها حجم إيران وحجم تركيا، وما بينهما… من اليمن امتداداً إلى العراق وسوريا ولبنان.
GMT 19:34 2025 الأربعاء ,12 آذار/ مارس
مسلسلات رمضان!GMT 11:05 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
ريفييرا غزة!GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًاحاكم مصرف لبنان بتعهد بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده
بيروت - لبنان اليوم
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية ...المزيدكندة علوش تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي» مؤكدة أنه شكّل لها تحديًا كبيرًا بعد فترة توقف عن التمثيل
القاهرة - لبنان اليوم
تحدثت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي»، مؤكدة أن الدور شكّل لها تحديًا كبيرًا، خاصة بعد فترة توقف عن التمثيل. قالت كندة علوش خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء ال�...المزيدأمازون تسعى للاستحواذ على تيك توك في صفقة مثيرة للجدل
واشنطن - لبنان اليوم
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية (أمازون) قدمت عرضا لشراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، قبل ساعات من بدء حظر المنصة في ال...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©