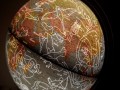الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ملاحظات حول المعتزلة
ملاحظات حول المعتزلة

عبد الغني سلامة
بقلم - عبد الغني سلامة
يكاد يتفق تيار العلمانيين و»الحداثيين الإسلاميين» على اعتبار «المعتزلة» بأنهم يمثلون المدرسة العقلانية المنفتحة في الفكر الإسلامي، وينظرون إليهم بوصفهم الصفحة المشرقة «الوحيدة» في تاريخ الحضارة الإسلامية.. فيما تصنف الجماعات السلفية المعتزلة بأنها من الفرق الضالة، أو في أحسن الأحوال بوصفهم خارج «أهل السنة والجماعة».. فمن هم المعتزلة؟ وما هي أطروحاتهم؟
قبل الإجابة لنتعرف بما يمكن اختصاره إلى هذه الفرقة.
يسود اعتقاد لدى كثيرين بأن المعتزلة هم الذين اعتزلوا الفتنة، واتخذوا موقفا حياديا في الأحداث التي جرت في صدر الإسلام، فلم ينخرطوا مع الجموع التي قتلت عثمان بن عفان، ولم يشاركوا في معارك الإمام علي (الجمل، وصفين، والنهروان)، حيث وقفوا خارج الاقتتال.. بينما الحقيقة أن المعتزلة ظهروا لأول مرة في القرن الثاني الهجري، مع اعتزال «واصل بن عطاء» مجلس أستاذه «الحسن البصري»، حين اختلف معه في الحكم على مرتكب الكبيرة.
كان «واصل» (القادم من المدينة المنورة) يلثغ في حرف الراء، لكنه كان من الفصاحة والذكاء بحيث أنه كان يقول كل شيء تقريبا دون هذا الحرف.. بيد أن ذكاءه لم يقتصر على هذا الأمر؛ إذ إنه أسس ما يُعرف بعلم الكلام، وبهذا العلم (الجديد)، تعمق في مسائل العقيدة، وانبرى للدفاع عنها، حتى صارت المعتزلة مقترنة بالفلسفة.
في هذه الأثناء شهدت البصرة أجواء من حرية التفكير والتعبير بحيث سمحت بنشوء المدارس الفكرية والفقهية المتعددة، فاتخذ واصل لنفسه مجلساً مستقلاً تفرد برأيه حول مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وأخذ يدرّس منهجه القائم أساساً على تقديم العقل على النقل في المسائل الدينية، إلى أن تبلور تياره الفكري القائم على خمس قواعد، هي:
التوحيد: إثبات وحدانية الله ونفي المِثل عنه، وتنزيهه عن الجسمية، أي التنزيه المطلق، والتوحيد بين الذات والصفات.
العدل: أي الربط بين صفة العدل في الذات الإلهية والأفعال الإنسانية، باعتبار أن الإنسان حر في أفعاله، وهو الذي يخلقها، فهو مكلف شرعيا ومسؤول عن أفعاله، حتى يستقيم التكليف، ويكون الثواب عدلا والعقاب عدلا.. خلافا للجبرية الذين يعتقدون أن الأفعال من خلق الله والإنسان مجبور عليها.
المنزلة بين المنزلتين: أي أن الفاسِق في الدنيا لا يُسمّى كافراً ولا مؤمناً، بل هو في منزلةٍ بين هاتين المنزلتين، فإن تابَ رجع إلى إيمانه، وإن مات مُصرّاً على فسقه فهو في النار.
الوعد والوعيد: أي إنفاذ الله لوعده في الآخرة على أصحاب الكبائر، وأن الله لا يقبل لهم شفاعة.
الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر: وموقفهم من أصحاب الكبائر واحد، سواء كانوا حُكّاماً أو محكومين. لكن بالنصح والقول، أي التغيير باللسان، فلم يلجؤوا إلى اليد والثورة، إلا عند التأكد من القدرة على ذلك.
إضافة لقواعدهم الخمس، قال المُعتزِلة إن القرآن كلام الله وهو مخلوق، أي أنه مُحدَث وليس جزءاً من ذاته، قديماً بقِدمه، كما تقول المُشبِّهة والأشاعرة وغيرهم بأن القرآن قديم وأزلي، وهو كلام الله وصفة ذاته.
هذه المسألة عرفت في التاريخ الإسلامي بمحنة خلق القرآن، حيث جعل منها الخليفة المأمون عقيدةً رسميةَ للدولة، أراد توظيفها سياسياً لتوحيد الدولة، والقضاء على الانشقاقات، وتصفية جيوب الفساد والتخريب التي خلفتها حربه مع أخيه الأمين، فأخذ يتتبّع كل مُعارِض لها بالقتل والحبس والجلْد، وكان أبرز مَن تعرّض للاضطهاد لرفضه هذه المقولة الإمام أحمد بن حنبل.
منذ ذلك الوقت، اقترنت المعتزلة بالسلطة، فمن ناحية أرادت السلطة فرض أيديولوجية موحدة (فكرية وسياسية) في أرجاء دولة الخلافة، ومن ناحيتهم، رأى المعتزلة أن انتشار أفكار «الجبرية» تؤدي إلى تحجيم دور العقل وتغييبه، فدعوا إلى حرية العقل واستقلالية الإنسان في سلوكه، والتأكيد على مبدأي «التوحيد» و»العدل الاجتماعي»، ما أكسبهم تعاطف الناس، في عصر كثرت فيه المظالم الاجتماعية، وكثر فيه القول بتشبيه وتجسيم الذات الإلهية.
أهم ما ميز المعتزلة اعتمادهم على العقل مصدراً للتشريع، بعد القرآن، وبذلك فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه، بقولهم إنّ العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام والحسن من القبيح بشكل تلقائي.. أي أن المسلم العاقل قادر على الفهم والتأويل والتمييز بمفرده، دون الحاجة للفقهاء، وبهذا قوضوا أسس الكهنوت الإسلامي، وسحبوا البساط من تحت أقدام الفقهاء..
وأشهر أعلامهم: القاضي عبد الجبار، الكندي، أبو علي الجُبائي، الزمخشري، العلّاف، النظّام، الجاحِظ، ابن الراوندي (الذي انشق عنهم).
في عصر المأمون والمعتصم والواثق (الفترة التي اقترنت فيها السلطة بالمعتزلة)، ازدهرت الحريات أكثر، وهي الفترة الذهبية في العصر العباسي، بل في مجمل تاريخ الحضارة الإسلامية.
لكن الخليفة المتوكّل، أنهى هذه الحقبة، ووضعَ حداً لنفوذ المعتزلة، مع أن المتوكل لم يكن متدينا، أو متعمقا في الفلسفة، بحيث نقول إنه انقلب عليهم لأسباب فكرية أو عقائدية، والسبب الحقيقي كان رغبة منه في الانتقام من أخيه الواثق، الذي كان يهينه في مجلس الخلافة، أمام وزرائه الذين كانوا من المعتزلة، فلما دانت إليه الخلافة، نكل بهم، وأحرق كتبهم، وفرض سبّهم على المنابر.
وكان هذا أحد أهم الأسباب في تلاشي فكر المعتزلة، وضياع نتاجهم الفكري، وبالطبع هناك أسباب أخرى؛ فالمعتزلة لم يتحولوا إلى طائفة، أو جماعة (كسائر الفرق والمذاهب)، بل ظل فكرهم نخبوياً، مقتصراً على فئة المثقفين، وبالكاد وصل الشيء النزير منه إلى العامة، نظراً لصعوبته..
ثم كثرت الخلافات الفكرية داخل أوساط المعتزلة، فخرج منهم، وانشق عليهم كثيرون، أشهرهم الأشاعرة، والزيدية، والإباضية، وغيرهم، من الذين ورثوا أجزاء متفرقة ومتباينة من تراثهم الفكري..
ومنذ ذلك الحين أخذ تيارهم الفكري ينحسر حتى كاد يتلاشى، بيد أنه ظل شعاع نور، يستنير به كل من احترم عقله وآمن به.
لا يمكن الحكم على فكر المعتزلة بمعايير العصر، بل يجب وضعه ضمن سياقه التاريخي، فقد مثَّل نقلة نوعية في الخطاب والفكر الإسلامي، دعا للتفكير، وأعلى من شأن العقل، في ظل مُناخ من الحرية والتسامح، نفتقر إليه اليوم.
GMT 00:53 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير
فخامة الرئيس يكذّب فخامة الرئيسGMT 21:01 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر
بايدن والسياسة الخارجيةGMT 17:00 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر
أخبار عن الكويت ولبنان وسورية وفلسطينGMT 22:48 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
عن أي استقلال وجّه رئيس الجمهورية رسالته؟!!GMT 18:47 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب عدو نفسههجوم من حزب الله على إجراءات مصرف لبنان يفتح مواجهة سياسية تتجاوز البعد المالي
بيروت ـ لبنان اليوم
توقفت الأوساط السياسية والاقتصادية في لبنان أمام الهجوم الذي شنه الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الاثنين، على إجراءات حاكميّة مصرف لبنان (المركزي)، ليفتح الباب أمام مواجهة سياسية جديدة تتجاوز الطابع ال�...المزيدياسمين عبد العزيز تتحدث بصدق عن تجاربها الشخصية وتكشف أسرارا لم تُحكَ من قبل
القاهرة ـ لبنان اليوم
نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأخبار التي تتعلق بارتباطها مؤخرا، مؤكدة على أنها سعيدة حاليا بكونها غير مرتبطة.وقالت "عبد العزيز" خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عب...المزيدالسعودية تحقق المركز الثالث عالميا في نماذج الذكاء الاصطناعي
الرياض ـ لبنان اليوم
سجَّلت السعودية إنجازاً جديداً، بعد أن حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وفي نسبة نمو الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أميركا والصين في النماذج اللغوية، وبعد الهند والب�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©