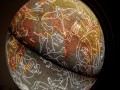الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مفاتيح للتفكير في لبنان..!!
مفاتيح للتفكير في لبنان..!!

حسن خضر
بقلم : حسن خضر
تكمن فتنة شعار «كلن يعني كلن» في بساطته، وعاميّته. والواقع أن ثمة ما يشبه ردّة فعل أتوماتيكية، تُبرّر وتفسّر نفور أغلب الناس في العالم العربي من الفصحى، وبلاغتها المدوّية كطبل أجوف.
ومع ذلك، فإن الكلمات الثلاث، التي يُراد لها، ومنها، إعلان القطيعة ما بين قطاعات واسعة جداً من اللبنانيين والنخب المُهيمنة، والسائدة، في بلادهم، تختزل واقعاً يتجاوز اللحظة المأساوية الراهنة ليعيدنا إلى لحظة نشوء الكيان اللبناني نفسه. فلا شيء يفنى، أو يُخلق من عدم.
ولا نملك، هنا، بالتأكيد، قطع كل هذه المسافة في الزمن. ولكن يكفي القول إن في تاريخ لبنان ما يختزل مصائر وتواريخ الفسيفساء الطائفية والقومية واللغوية، التي هبّت عليها، وعصفت بها، أقدار وتحوّلات عاتية، رمتها على مفارق طرق الإمبراطوريات، وكان عليها أن تتحوّل إلى أمم وشعوب في المشرق العربي بعد انكسار الحاضنة العثمانية، واكتشاف وجودها ضمن حدود سياسية جديدة لم تشارك في رسمها.
وها قد مضى على انخراطها في تصوّرات ومشاريع دولة/أمة ما يزيد على قرن من الزمان، ولكنها لم تشف بعد من جراح الولادة القيصرية، ولا من آلام البتر التي حلّت بفلسطين، وموجاتها الارتدادية.
لا يختزل لبنان هذا كله وحسب، بل ويبدو حالة فريدة، أيضاً. فلم يسدد بلد فواتير كل ما أصاب بلاد الشام، أو تتجلى في هويّته صدمة الولادة القيصرية، وآلام البتر، بأثر رجعي، كما حدث للبنان.
هل هو من الشرق أم الغرب؟ وهل هو عربي تماماً؟ وهل تتطابق هويته مع حدوده السياسية، أم أن الحدود السياسية تضيق بها وعليها؟ وهل ثمة فكرة واحدة مُوّحَدة ومُوّحِدة أم أن الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية تحول دونها؟
ولكي لا تأخذنا الظنون لوصم تساؤلات كهذه بالهرطقة ينبغي التذكير بحقيقة أن أسئلة كهذه طُرحت في بلدان كثيرة.
لوغوس طه حسين الإغريقي، مثلاً، وتأملات خير الدين باشا التونسي، وعلامات استفهام أنطون سعادة بشأن الفرق بين عروبة بلاد الشام، والجذور الدينية والبدوية للقومية العربية.
نذكر هذا كله للتذكير بحقيقة أن أسئلة لبنان كانت شرعية ومشروعة، ولكن تلفيقات ميشيل عفلق عن روح القومية وجسدها، وتنافس الناصرية، وحركة القوميين العرب، ذات القشرة النظرية الرقيقة، مع البعث، أفقر الفكرة القومية نفسها، وعمّق ميولها الشعبوية التعبوية، ونفاد صبرها بشأن التعددية والاختلاف. فلا سورية الأسد، ولا عراق صدّام، كانت دولة لكل مواطنيها، ولم يثر هذا انتباه أحد حتى وقت قريب.
وعلاوة على هذا كله، ثمة المصائر المأساوية، تماماً، للمسيحية الشرقية، وكل الميراث الديني والثقافي للإمبراطورية البيزنطية في الشرق الأوسط. (تبرز في الذهن، هنا، أيا صوفيا، ولكن بنظرة أوسع لا يبدو من قبيل الصدفة أن ينتهي هذا كله بصراع عثمانية الأناضول التركية المُستحدثة، والوهابية النجدية، وولاية الفقيه الإيرانية، في بلاد الشام وعليها).
والمهم، في هذا كله، القول إن ثمة خصوصيات وثيقة الصلة بالمجتمع والدولة اللبنانيين. فكلاهما هش: الأوّل لا تُوّحده فكرة الدولة، لأن فكرة الدولة نفسها، وبالصيغة التي وُلدت بها لا تحظى بالإجماع حتى نتيجة أسباب ديمغرافية متغيّرة، والدولة لا تستطيع مقاومة الضغوط الخارجية، بـ»الوحدة الوطنية» إلا إذا نالت الاعتراف الطوعي من المجتمع بالحق في احتكار وسائل العنف.
ولم يكن في هذا كله ما يمكّن أحداً، في لبنان، من النجاة من الهزّات الارتدادية للنكبة الفلسطينية 1948، وانقلاب حسني الزعيم في دمشق 1949، الذي افتتح سلسة انقلابات عسكرية استمرت حتى مطلع السبعينيات، وإطاحة الضباط الأحرار في القاهرة بالملكية 1952، وصعود نجم عبد الناصر. ولنلاحظ أن هذه التحوّلات، وكلها من عيار تاريخي، وقطع كبير، وقعت في وقت قصير فعلاً، بالمعنى الزمني، وأن صداها تردد في لبنان أكثر من أي مكان آخر، نتيجة إكراهات الجغرافيا بآلامها وحدودها السياسية المُستحدثة، والضيّقة، من ناحية، وخصوصيات المجتمع والدولة اللبنانيين من ناحية ثانية.
فلنضع موضوع الفلسطينيين جانباً، سنأتي على ذكره في معالجة لاحقة. ويكفي التذكير، في هذا السياق، بحقيقة أن القاهرة، لا دمشق، كانت صاحبة النفوذ الأكبر في لبنان، وقد تكرّس هذا النفوذ بطريقة رسمية، ومشحونة بدلالات رمزية سياسية كثيفة، في اللقاء الذي جمع عبد الناصر برئيس الجمهورية اللبنانية فؤاد شهاب، في خيمة على الحدود اللبنانية ـ السورية العام 1959.
تم اللقاء بين الجانبين في خيمة نصفها في سورية والآخر في لبنان. وثمة ما يكفي من الشواهد للقول إن النفوذ المصري استمر حتى اندلاع الحرب الأهلية 1975، وإن اللبنانيين، حتى ذلك الوقت، كانوا يراهنون على دور للقاهرة، ولكن خيارات مصر الساداتية لم تكن متطابقة مع خياراتها في زمن عبد الناصر.
وبقدر ما يتعلّق الأمر بدمشق فلنلاحظ أنها لم تفتح سفارة لها في بيروت منذ نشوء الكيان اللبناني وحتى العام 2009، وهذا ما يمكن صياغته بألفاظ محايدة بالقول إن حدود لبنان السياسية كدولة مستقلة لم تكن مضمونة، أو مُستقرة، على مدار عقود طويلة في العلاقة بين البلدين.
والواقع أن انسحاب القاهرة الطوعي من دورها في العالم العربي، والإقليم عموماً، تصادف مع استقرار نسبي للنظام في دمشق، ومكّنه من التدخّل، بأشكال مختلفة، كقوّة وصاية عسكرية مباشرة على الأرض، وعبر وكلاء، منذ أواسط السبعينيات وحتى الآن.
هذه مفاتيح للتفكير في لبنان، أجدُ ما يبررها في انفجار بيروت، الذي يبدو كعلامة فارقة في تاريخ لبنان، والمنطقة عموماً. ولنا عودة فالمفاتيح كثيرة.
قد يهمك أيضا :
GMT 19:34 2025 الأربعاء ,12 آذار/ مارس
مسلسلات رمضان!GMT 11:05 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
ريفييرا غزة!GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًاترامب يعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات مع تقديم مرونة لبعض الشركات
واشنطن - لبنان اليوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه سيعلن عن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، مضيفا أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في القطاع. ويعني تعهد الرئيس أن استثناء الهواتف الذ�...المزيدأمينة خليل تكشف كواليس دورها في "لام شمسية" وتبكي تأثراً بكلمات الطفل علي البيلي
القاهرة - لبنان اليوم
حقق مسلسل "لام شمسية" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث حصد المسلسل إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، وتحدثت بطلة العمل الفنانة المصرية أمينة خليل عن كو...المزيدشركة أمازون تظور نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي "نوفا ريل" ليصل الى دقيقتين
واشنطن - لبنان اليوم
قامت شركة أمازون بتحديث نموذجها للفيديو بالذكاء الاصطناعي، "نوفا ريل"، ليتمكن من إنتاج فيديوهات تصل مدتها إلى دقيقتين.أُعلن عن نموذج "نوفا ريل" في ديسمبر 2024، وكان أول دخول لشركة أمازون في مجال إنتاج الفيد...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©