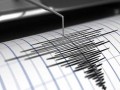الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
وقد تكون المصالحة ضحية الانتخابات الأميركية...!
وقد تكون المصالحة ضحية الانتخابات الأميركية...!

أكرم عطا الله
بقلم : أكرم عطا الله
وتستمر مرحلة التيه الفلسطيني في صحراء السياسة باحثة عن شجرة خضراء وسط الرمال الجافة، وبدت في لحظة أنها متعثرة ليس فقط بفعل أربع سنوات عجاف من حكم الرئيس ترامب الذي استغل كل ما يملك من جهل، وليس أيضاً فقط بفعل انزياح اسرائيلي غير مسبوق نحو يمين لم يعد يؤمن بحل دولتين أو بوجود شعب آخر على هذه الأرض، ولا فقط بفعل تحطم الإقليم خلال العقد الماضي بل أيضا بفعل التخريب الداخلي الذي مارسه الفلسطيني ضد نفسه عندما حطم بوصلته ومؤشرها، فسار بلا هدى معتقداً أن السياسة هي مجموعة محاولات.
جزء من أزمة الإقليم الذي شكل الظهير الاستراتيجي للفلسطينيين هو إضعاف عواصم المركز التاريخية أو تحطمها ونقل مركز القرار في العقد الأخير نحو دول الهامش، وهذا أحدث اضطراباً أظن أن المنطقة العربية لن تشفى منه قريباً. ومنذ طفرة النفط حين بدأ انتقال مركز الثقل الاقتصادي هناك ثم في النصف الثاني للتسعينات وظهور الفضائيات بدأ مركز الثقل الإعلامي ينتقل، ثم بتحطيم كبرى العواصم القومية ينتقل الثقل السياسي ليبدو الفلسطيني مجرداً من عواصمه التاريخية، في اطار البحث عن الطريق جرت محاولات التوافق في اطار القبيلة المتناحرة دون أن تنجح أي منها، بل كان التشتت يزداد أكثر إلى أن اصطدم الجميع بالجبل، وكأنه كان يجب أن تنكسر الرؤوس لتدرك عمق المأساة التي حسدتها كل المناورات والمناوشات ورحلة الخداع الداخلي، ليكتشف الفلسطيني أنه كان يلهو ولا يمارس السياسة، وأن الثمن كان أكبر من يتحمله شعب وقضيته، إلى أن دفعه ضغط اللحظة أن يذهب إلى حوار يبشر أنه مختلف.
ذهب الفلسطيني إلى أنقرة، وهو خيار لم يكن الأمثل في ظل الصراع الاقليمي، الأمر كأنه يرسل رسالة سلبية لمن اعتبر دوما الحليف الأقرب، وكان يمكن إذا ما قرر الفلسطيني في لحظة ضغط أنه وصل إلى النهاية أن يذهب إلى موسكو التي أدارت حوارات سابقة، هذا إذا لم تكن القاهرة التي تكفلت بهذا الملف، فروسيا أقدر على مخاطبة اسرائيل فيما لو بدأ تطبيق اتفاق مصالحة ولا تتسبب بالحساسية التي يسببها الذهاب نحو أنقرة في هذا الظرف.
على كل حوار رغم المكان غير المثالي ولكنه حدث، ويأمل الجميع أن يكتمل وليس كما الحوارات التي وصلت أبعد منه، وأبرزها حوار العام الماضي الذي أداره رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي أنهى محاولته التي كادت تنجح بتوقيع الفصائل على التفاصيل، ولكن حينها كان الضغط فقط على المواطن، أما هذه المرة فوصلت للمسؤولين جميعاً.
ربما من المبكر نقاش التفاصيل وإن انشغل بها الرأي العام ومجموعات من المفكرين والمثقفين في مجموعات متناثرة على «الواتس آب» وغيره، تتناقش لوحدها وبلا رابط بينها في الانتخابات والقائمة الموحدة التي يجري الحديث عنها بين حركتي فتح وحماس، وحجم الاعتراضات القائمة من الخارج وإن لم تبدأ بعد الاعتراضات الداخلية.
فبعد خمسة عشر عاماً «هذا إن جرت الانتخابات مطلع العام القادم» جعلت طوابير المرشحين أكبر كثيراً من أن يكفيها مجلس تشريعي رغم توسع أعداده من 88 إلى 132 بلا لزوم سوى استيعاب أكبر عدد من المرشحين، ولكنه لم يعد يكفي.
الحديث المبكر من عودة القيادات السابقة بما لها وما عليها يستدعي حديثاً آخر عن ضرورة ليس فقط تجديد شرعية المؤسسة، بل تجديد دم المؤسسة بأجيال جديدة لديها ما تقوله بعد الاختيار الطويل لمن كانوا في الطبقة السياسية لسنوات طويلة، وقدموا النموذج الذي أمامنا قبل هذا الاصطدام.
ولكن الحقيقة وقبل أن نذهب للتفاصيل، نحن أمام حدث قد يغير كل ما هو قائم يتمثل بالانتخابات الأميركية، فمشروع المصالحة الأخير ليس هناك شك أنه جاء تحت تأثير ضغط التحالفات مع الحزب الجمهوري الأميركي والرئيس ترامب، وبالتالي قد تكون إحدى نتائجها أن يفوز بايدن مرشح الحزب الديمقراطي والذي يدعو لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، أي عودة لسياسة أوباما القديمة وتلك المفاوضات تستدعي الالتزام باتفاقيات أوسلو.
المكالمة التي تم تسريبها لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي يعتقد أنه تم تسريبها متعمداً لتصل لحركة فتح والرئيس محمود عباس، جاء فيها أن الحركة ستدخل الانتخابات لتدفع نحو التنصل من كل ما يتعلق بأوسلو وملحقاته، وبالتأكيد هذا يتعارض مع المفاوضات،
لذا علينا الانتظار لثلاثة أسابيع حتى الثلاثاء الكبير، وحين يصعد الدخان الأبيض سنعرف حينها، فإن فاز ترامب سيختلف الأمر وقد تستمر المصالحة، أما إن فاز بايدن ستتغير أشياء كثيرة في صالح الرئيس عباس، ومنها تعامل دول عربية وحركة المساعدات المالية، ولكن حينها قد تكون المصالحة هي الضحية... ننتظر قبل الدخول بالتفاصيل...!
GMT 14:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
الحضارة بين العلم والفلسفة أو التقنية والإدارةGMT 18:25 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الخاسر... الثاني من اليمينGMT 18:10 2024 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
جمعية يافا ومهرجان الزيتون والرسائل العميقةGMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!"إنفيديا" تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم بفضل طفرة في الذكاء الاصطناعي
واشنطن - لبنان اليوم
حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت». فقد شهدت الشركة ارتفاعاً في الطلب على أشباه الموصلات التي تستخدم لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأفادت «إنفيديا»، يوم الأربعاء�...المزيدمنة شلبي تتألق في موسم الرياض بمسرحية شمس وقمر وتعيد الأفلام الرومانسية إلى الصدارة بفيلم الهوى سلطان
القاهرة - لبنان اليوم
النجمة المصرية منة شلبي كشفت مفاجأة فنية جديدة لها في نهاية 2024، حيث أعلنت خوضها تجربتها المسرحية الأولى في مسيرتها الفنية، من خلال مسرحية "شمس وقمر"، والتي تستعد لعرضها في موسم الرياض في الفترة المقبلة. وشوقت ...المزيداندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
طوكيو - لبنان اليوم
اندلع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبار صاروخ "إبسيلون إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه". وأظ�...المزيدتصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالمياً في مجال حفظ القرآن الكريم
الرباط - لبنان اليوم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميًا في مجال حفظ القرآن الكريم. يعد هذا التكريم شهادة جديدة على عراقة وتقاليد المغرب في مجال العناية بكتاب الل...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©