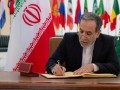الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
فرصة إضافية ... ضائعة
فرصة إضافية ... ضائعة

شارل جبور
بقلم : شارل جبور
أظهرت الوقائع منذ العام 2005 انّه في كل محطة كانت تقترب فيها الأمور من الحسم، كان يبرز تحالفٌ ما تحت مسمّى «رباعي» او «خماسي»، ليجهض الأمل بالتغيير، فهل تتكرّر المحاولة مجدّداً؟
أحد الجوانب الإيجابية للأجسام الطائفية يتمثّل بتجذّرها في البنيان المجتمعي اللبناني، الأمر الذي حال دون ضرب وجه لبنان التعدّدي، وشكّل عائقاً أساسياً أمام «تتريك» لبنان و«سورنته». فلو كان هذا المجتمع قائماً على الفرد فقط لا الجماعات، لكان تحوّل البلد إلى محافظة سورية، او تتطلب الوضع عشرات السنوات لولادة حركة تحرّر شعبية، فيما النظام السوري لم يتمكّن من خرق البنيان الطائفي، على رغم إطباقه السياسي على الواقع اللبناني. وفي اللحظة التي تقاطعت فيها التكتلات الحزبية - الطائفية نجحت بإخراج الجيش السوري من لبنان.
ومن إيجابيات الأجسام الطائفية ومحاسنها ايضاً، أنّها تمنع طائفة واحدة من الهيمنة على البلد. فتلغي التنوع والتعدّد والحرّية والديموقراطية، وتكرِّس مفاهيمها الدينية والدنيوية، فيما التنوع الطائفي يحول دون هذه الهيمنة بفعل التوازن الذي يجسِّده، الأمر الذي يوفّر المساحة المطلوبة من الحرّية لجميع الطوائف ويتيح للأفراد أوسع هامش ممكن لحركيتهم ونمط عيشهم.
وما تقدّم، لا يعني عدم تطوير النظام السياسي باتجاه تغليب المواطنة على اي اعتبار آخر، والفصل التام بين ما هو ديني وما هو مدني. ولكن هذا التطوير لا يتحقق بموقف وقرار و«كبسة زر»، كما انّه ليس من مسؤولية جماعة من دون أخرى، بل هو مسؤولية مشتركة ويتطلّب وعياً سياسياً، وتحقيقه لا يكون بالتذاكي، عن طريق الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية وتقديم مشاريع قوانين انتخابية، شكلها عصري وحديث وجوهرها تحكيم طائفة بالطوائف الأخرى، إنما تحقيق التطوير يبدأ مع قيام الدولة وولاء كل مواطن لهذه الدولة. ولذلك، فإنّ الهدف الأساس يجب ان يتركّز على الدولة التي تشكّل أساس البنيان اللبناني والمشترك بين الجماعات والأفراد. وبالتالي، اي تطوير يبدأ مع إشعار الفرد انّ مرجعيته هي الدولة. وما قبل تحقيق هذا الهدف، فإنّ كل تحديث للنظام مشكوك بأمره وغاياته وخلفياته.
فلولا التقاطع المسيحي والسنّي والدرزي وشريحة مدنية واسعة في العام 2005، لما خرج الجيش السوري من لبنان. حيث وجد النظام السوري نفسه في مواجهة مع الكنيسة المارونية والحريرية والجنبلاطية السياسية، والتوازن الذي أحدثته 14 آذار في مواجهة 8 آذار، إرتكز الى ثلاثية «القوات» و«المستقبل» و«الإشتراكي» والأحزاب الأخرى من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، ولكن في اللحظة التي تباين فيها هذا الثلاثي للاعتبارات المعلومة، تفكّكت الجبهة السيادية، فيما لم يتمكن المجتمع المدني من ان يشكّل الرافعة لهذا المشروع، ولا ان يشكّل عاملاً ضاغطاً على الثلاثي، من أجل تماسك الجبهة السيادية، ما يعني انّ نقطة الارتكاز كانت حزبية بامتياز.
وفي موازاة إيجابيات الأجسام الطائفية، فإنّ من سلبياتها غياب التنوّع داخل بعض الطوائف واختزالها بفريق سياسي واحد. هذا الفريق، الذي لاعتبارات واقعية وبراغماتية، يسلِّم بتوجهات تتناقض مع أهدافه المعلنة منذ العام 2005. وهذا ما حصل في اتفاق الدوحة وانتخابات العام 2009 والتسوية مع حكومة الرئيس تمام سلام التي لم تكتف بإعطاء المالية للثنائي الشيعي، إنما تراجعت عن رفض التعايش مع هذا الفريق، سوى في حال خروجه من سوريا وتسليم سلاحه، والذهاب إلى مرشح رئاسي من 8 آذار، بحجّة التخلّص من الفراغ الذي يشكّل خطراً على الدستور، وتجدّد التسوية اليوم تحت عنوان وجود فرصة لا يجب تفويتها، وبالتالي إن أدّى هذا المسار التراجعي والتنازلي الى شيء، فقد أدّى إلى تفويت الفرص الواحدة تلو الأخرى لقيام الدولة في لبنان.
فمن الثابت انّ هذا البلد لا يُحكم من قبل فريق واحد، ومن هو غير مقتنع بذلك ما عليه سوى ان يحاول. وفي المرتين اللتين حاول إبّانهما «حزب الله» ان يمسك منفرداً بالقرار السياسي للبلد، عاد وتراجع، مبدّياً التعايش على التفرُّد، إن مع التخلّي عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، او تخلّيه عن حكومة الرئيس حسان دياب. فلمس بالملموس انّ حكومات اللون الواحد لا تستقيم في لبنان، وبدلاً من تخييره بين ان يحكم منفردًا ويفشل ويتحمّل تبعات فشله أمام بيئته، وبين ان يبتعد طوعاً عن السلطة إفساحاً في المجال أمام الإنقاذ، ذهب البعض باتجاه التسليم بسقف الحزب وشروطه.
فالفرصة الحقيقية للإنقاذ لا تكون عن طريق تشكيل حكومة مع الفريق الحاكم مصيرها معروف سلفاً، إنما تكون من خلال التمسّك بحكومة مستقلة عن كل القوى السياسية، من أجل تحقيق الإصلاح ورفع يد الأكثرية عن السلطة. والأزمة المالية، على مساوئها الكبرى والتي سببها أداء هذه الأكثرية، شكّلت فرصة لكف يد هذا الفريق، ولكن، وللأسف، تمّ تفويت هذه الفرصة النادرة تحت عناوين طوباوية ومصلحية لا واقعية وإنقاذية. والأسوأ انّ التنازلات المستمرة منذ العام 2005 لم تفرمل الانهيارات المتتالية، لا بل فاقمت الأوضاع سوءاً.
ولم يصل البلد إلى ما وصل إليه سوى بفعل هذه الممارسة السياسية، التي تعتبر نفسها أحرص من غيرها على البلد، فيما الحرص يجب ان يكون مشتركاً. وعندما يبطل ان يكون كذلك تسقط الشراكة والمساواة لمصلحة فريق حاكم وآخر محكوم. وقوة «حزب الله» ليست بسلاحه وصواريخه، إنما بقدرته على تطويع إرادة غيره. والمواجهة المطلوبة معه ليست بالسلاح إطلاقاً، إنما بسلاح الموقف، فإما شراكة كاملة، أو فليحكم منفرداً، اي التنازل له طوعاً عن السلطة، لأنّه من غير المسموح ان يتحول خصم الحزب، بمعرفته او من دونها، إلى وسيلة وأداة في خدمة هذا الحزب.
وقد أصبح «حزب الله» في موقع المتحكِّم بأخصامه، بسبب تراكم التجربة معهم. ويكفي ان يعطِّل لينال ما يريد ولو بعد حين. ولو كان لديه أدنى شك بأنّ خصمه لن يتراجع لما عطّل ولما رفع سقفه، ولكن تشدّده تحوّل إلى تكتيك سياسي يستخدمه في كل مرة يسعى إلى تحقيق أهدافه ومآربه، فيما التكتيك المطلوب مع الحزب هو سياسة توازن الرعب وحافة الهاوية، وهي السياسة الوحيدة القادرة على تحقيق تسويات عادلة ومتوازنة.
ومن المؤسف ان تكون البلاد أمام فرصة ضائعة إضافية، بدلاً من رفع المواجهة إلى أقصاها لمرة واحدة وأخيرة، عوضاً عن هذا الترقيع المتمادي الذي أوصل لبنان إلى الهاوية. وما تجديد التسوية اليوم سوى خدمة لمشروع «حزب الله»، الذي يجد في كل مرة ينحشر فيها من ينقذه، الأمر الذي يُفقد الأمل بالإنقاذ الفعلي والحقيقي ويفوِّت فرصة جديدة، لا سيما انّ الحكومة التي ستتشكّل لن تكون سوى نسخة قبيحة عن سابقاتها، ولن تتمكن من تحقيق اي شيء، ليس فقط كون القوى التي فشلت في الإصلاح سابقاً ستفشل اليوم، بل لأنّ الإصلاح هو العدو الفعلي لهذا الفريق، الذي يفقد دوره ويتراجع في كل مرة يتقدّم فيها الإصلاح، وبما انّه لن يكون في موقع من يدمِّر نفسه سيواجه كل المحاولات الإصلاحية.
والتسوية الجديدة لا تخوِّف، كونها هجينة ولن تدوم لثلاثة أسباب أساسية:
السبب الأول، عجزها عن معالجة الأزمة المالية. ولن يكون مصير الحكومة العتيدة أفضل من مصير الحكومة المستقيلة، خصوصاً انّ الشروط الدولية واضحة، لا مساعدات من دون إصلاحات، والإصلاحات متعذرة بل مستحيلة مع هذا الفريق الذي لن يُقدم على إعدام نفسه.
السبب الثاني، لأنّ المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة، او بالأحرى استمرار وتسريع المزيد من الخطوات نفسها بعد الانتخابات الأميركية، وذلك لجهة السلام العربي - الإسرائيلي وتطويق طهران لدفعها إلى التفاوض فالتنازل. ويرجّح ان يكون العام المقبل مفصلياً على مستوى الشرق الأوسط. وكل ما يحصل على الساحة اللبنانية اليوم لا يتجاوز شراء الوقت، للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة او اللعب في الوقت الضائع.
السبب الثالث، لأنّ التسوية تفتقد إلى الحاضنة الخارجية والحاضنة الشعبية الداخلية. فلا ثقة للخارج بالطبقة الحاكمة، ويتعامل معها على قاعدة أمر واقع وأفضل من الفراغ. كما لا ثقة شعبية، وتراجع وهج الانتفاضة وديناميتها لا يعني انّ الناس استسلمت للأمر الواقع، إنما في الوقت المناسب قد يعود الدفق الشعبي المليوني، ليُسقط الحكّام في الشارع او في صناديق الاقتراع. ولكن الثابت والأكيد، انّ هناك كتلة شعبية عابرة للطوائف والمناطق تقف بالمرصاد في مواجهة الطبقة الحاكمة، وما رفضها للانتخابات المبكّرة إلاً خوفاً من كلمة الناس.
وتبعاً لما تقدّم، فإنّ هذا التحالف بين الأضداد، والذي تجمعه السلطة، لم يعد مقنعاً ولا جاذباً، ولن يتمكن هذه المرة من ان يحكم متربعاً، وسيكون أمام فشل حتمي. ولبنان أمام تغيير جذري. ولكن العبرة من كل ذلك، انّه إذا كانت الجماعات تشكّل حاجة للحفاظ على التوازن ودور لبنان وطبيعته، بانتظار قيام الدولة وإعلاء المواطنة، فإنّه من دون وزن فعلي للمساحة المدنية داخل كل الطوائف، كعامل ضغط ليس للمزايدة إنما منعاً للتسويات غير المتوازنة على حساب الدولة، فيعني انّ تفويت الفرص على حساب البلد والناس سيتواصل. لأنّه كما انّ التوازن مع «حزب الله» ضرورة وطنية بين مشروعين، فإنّ هذا التوازن ضرورة ايضاً داخل كل بيئة، تحقيقاً للمساواة ودفعاً لمشروع الدولة ومنعاً للتنازلات وحرصاً على انتظام الحياة العامة.
GMT 19:34 2025 الأربعاء ,12 آذار/ مارس
مسلسلات رمضان!GMT 11:05 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
ريفييرا غزة!GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًارئيس الوزراء اللبناني يعتزم إعلان مشروع قانون مصرفي طال انتظاره
بيروت ـ لبنان اليوم
يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يعلن مساء الجمعة، عن مضمون مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، ويهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ الع�...المزيدتسلا تكشف عن روبوتها الشبيه بالبشر اوبتيموس في برلين
برلين - لبنان اليوم
كشفت شركة «تسلا»، السبت، عن روبوتها الشبيه بالبشر المُسمى «أوبتيموس» أمام الجمهور في العاصمة الألمانية برلين.وقام الروبوت بتوزيع الفشار في سوق لعيد الميلاد بمركز التسوق «إل بي 12»، المعروف أيضاً ب�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©