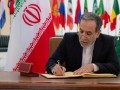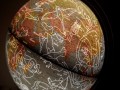الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
طه حسين و«الحديث بنقيض هذا»
طه حسين و«الحديث بنقيض هذا»

بقلم: علي العميم
كتاب «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» كتاب معروف عند دارسي الأدب العربي الحديث ونقاده وعند المعنيين بالتاريخ الأدبي والثقافي والسياسي والاتجاهات الفكرية في مصر من قيام الثورة العربية إلى قيام الجامعة العربية، فهو مصدر رئيسي في هذه الموضوعات لا غنية عنه. ولهذا فصاحبه محمد محمد حسين، يحظى بتقدير وتثمين عند هؤلاء مع تصنيفهم له بأنه في هذا الكتاب، مؤرخ سلفي محافظ، ومتشدد في رفضه للانفتاح على الثقافة الغربية والتأثر بقيمها ومُثلها، وبمواضعاتها السياسية والقانونية والاجتماعية والفكرية.
فتثمينهم لكتابه هذا هو الذي جعل رجاء النقاش يصفه بالعالم الكبير، ويعبر عن اختلافه معه بإجلال وتوقير. ولهذا السبب الذي أشير إليه نجد أن غالي شكري في مقدمة أول كتاب له «سلامة موسى وأزمة الضمير العربي»، وهو الراديكالي في يساريته وحداثيته، والمفاصل والحدي في حديثه عمن يصنفهم في خانة الرجعية الأدبية والرجعية الثقافية والرجعية السياسية والرجعية الدينية، يقول: «وأنا لا ألتفت لحظة إلى كتابات التافهين من المرتزقة الذين هم ليسوا إلا جنوداً مجهولين خلف واجهات تستمد بريقها من القديم وهو يلفظ أنفاسه. ولكني أرثي كثيراً لقلة قليلة من أساتذة جامعاتنا عندما يمسكون المعاول بغير قصد ليحطموا ما لا قبل لهم بتحطيمه، لأنه أصبح والتاريخ شيئاً واحداً، يقاوم الزمن. فكيف بأولئك المضللين - على أحسن الفروض - عندما يقول أحدهم هو الدكتور محمد محمد حسين في كتابه (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) – أن سلامة موسى كان داعية للاستعمار!».
إن غالي شكري، وهو في حميا ماركسيته وشبابه، يعتذر لمحمد محمد حسين بأنه أمسك المعول بغير قصد، ويحسن الظن به بأنه مضلل، غاضاً بصره عن ما نضح به كتابه من غلو في انتصاره للقديم في الأدب والثقافة والحياة الاجتماعية.
النتيجة التي خرج بها رجاء النقاش من رده «طه حسين في قفص الاتهام» ذي الجزأين المنشورين في مجلة «الهلال» عام 1977 على كتاب أنور الجندي «طه حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام»، ومن رده «محاكمة ظالمة لطه حسين» على كتاب عبد المجيد عبد السلام المحتسب «طه حسين مفكراً» المنشور في مجلة «الدوحة» عام 1979، كتبها في مقاله «هل نحن على أبواب حرب أهلية في ميدان الفكر والثقافة؟!» الذي عرضنا أبرز أفكاره في المقال السابق.
النتيجة هي أن بعض الأدباء والكتاب والمفكرين والزعماء كانوا اتخذوا «مواقف مؤقتة»، تبدو خاطئة، لكن هدفها العام سليم ومقبول. ثم يأتي من «يطالب بمصادرة هؤلاء... والوقوف في وجههم. وفرض مقاطعة أدبية وفكرية عليهم وإحراق ما أنتجوه وما كتبوه».
وكان قد أتى بمثالين لما سماه «المواقف المؤقتة»، وهما: مثال محمد عبده ومثال طه حسين.
هذان المثالان - كما قدمهما - كانا غير متساوقين. ففي مثال محمد عبده ثمة خطأ سياسي أوضحه في هذا المثال، وهو مهادنته للورد كرومر وتعاونه معه، لكن في مثال طه حسين ليس ثمة خطأ سياسي ارتكبه بعد توليه وزارة المعارف عام 1950، فما قيل عنه بعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 في أثناء توليه أمر هذه الوزارة - كما في استعراضه هذا المثال - كان محض أكاذيب. وبالتالي، فهذا المثال لم يكن يعبر عما قاله في «المواقف المؤقتة» وعنها، إلا أن يكون قصد بهذا المثال أن مدح الملك فاروق خطأ سياسي.
وهو - بالفعل - قصد هذا الأمر. فبعد أن نقل فقرات من مقال طه حسين الذي دافع فيه عن نفسه، علق قائلاً: «هذا هو موقف طه حسين عندما اضطر إلى مدح الملك فاروق، وتبرير طه حسين لموقفه هو في أي ميزان عادل تبرير سليم إلى أبعد الحدود. فقد أحنى رأسه في موقف ليكسب لشعبه وأمته كثيراً من الخير الحضاري الذي ما زلنا ننعم به حتى الآن سواء في مجانية التعليم أو في إنشاء الجامعات الجديدة».
إن مدح طه حسين للملك فاروق لا يمكن عده خطأ سياسياً متفقاً عليه عند جميع الأطراف في المجتمع السياسي المصري. إنه خطأ سياسي وخطأ سياسي شنيع عند المغالين في تأييد ثورة 23 يوليو وتأييد زعيمها جمال عبد الناصر.
يقول مصطفى عبد الغني في خاتمة كتابه «طه حسين والسياسة»: «فبمجرد أن قامت ثورة 52 حتى استمر تأييد طه حسين لها ولرجالاتها دون تحفظات، فهو تارة يبارك الجيش فيما فعل، وهو تارة أخرى يؤيد أن تتحرك الثورة لتحمي نفسها من جموح بعض الأقلام حتى تطمئن إلى بلوغ غاياتها، وفي تارة ثالثة لا يتردد في توجيه الشكر المباشر، ولمرات معدودة لحكومة الرئيس جمال عبد الناصر، مهنئاً إياه بنجاته من محاولة (الإخوان) اغتياله، مسمياً هذه المحاولة بالشر العظيم».
ويضيف قائلاً: «ويتوالى تأييد الثورة في كل مراحل تطورها، فإذا ذُكر العهد السابق ذكر النفاق، وذكر ما سام مصر من النفاق للملوك وحواشي الملوك، متناولاً بالقدح العنيف هذه الأنساب الكثيرة التي كانت تتردد للأسرة المالكة دون توجيه نقد واحد للقوى الجديدة».
توسع مصطفى عبد الغني في عرض موقف طه من ثورة يوليو في كتاب ثانٍ له، هو كتاب «طه حسين وثورة يوليو: صعود المثقف وسقوطه». وأعاد الحديث فيه في كتاب ثالث، هو كتاب «المثقفون وعبد الناصر».
ومما قاله في الكتاب الثالث: «ورغم أن طه حسين كان في هذا الوقت يكثر من الحديث عن الديمقراطية، فإن دعوته إلى تأييد الثورة كان أغلب ما ميز كتاباته، فكثيراً ما راح يعلن ارتياحه لسقوط الدستور، وكثيراً ما أكد أن استفتاء الشعب للاختيار بين الملكية والجمهورية ينتهي دائماً إلى أمر واحد يجب الأخذ به قبل هذا الاستفتاء، وهو تقرير النظام الجمهوري، وهو كثيراً ما يهاجم العهد الملكي الماضي هجوماً عاتياً... ويغلو في التأييد المطلق، ويلاحظ أن هذا التأييد يتماشى تماماً مع خط الثورة الجديدة التي كانت تتلمس في الحركة البراغماتية السبيل الوحيد للسير في الطريق الجديد، فلا تطلق الثورة أي شعار إلا ويؤيدها، سواء كان هذا في تحبيذ النظام الجمهوري أو تأكيد استمرار الفترة الانتقالية التي دعت الثورة إليها ونفذتها، ويصل التأييد المطلق عند طه حسين إلى درجة تحريض الثورة على المثقفين الذين يتخذون موقف المعارضة منها».
استناداً إلى عرض مصطفى عبد الغني لموقف طه حسين من ثورة يوليو، يمكنني أن أقول: «لم يخطئ طه حسين سياسياً حين مدح الملك فاروق ما دام أنه قاله عن قناعة وكانت له مناسبة، بل أخطأ أخلاقياً حينما أسرف في النيل من النظام الملكي في مقام مدحه لرجال الثورة، بعد أن كان مدح هذا النظام، ممثلاً بفاروق وبأبيه فؤاد».
فمع مدح طه حسين للملك فاروق ولأبيه الملك فؤاد، وإزجاء الثناء العاطر لهما، فإنه كان يعالنهما الاختلاف في الرأي، مباشرة ومداورة، وتصريحاً ورمزاً؛ لأن علاقته بهما كانت تتراوح بين شد وجذب، وتتأرجح بين نفرة منه وتقريب له.
لنتأمل الفرق بين ما أتيح له من حرية الخلاف والاختلاف مع العهد الملكي وبين موقفه من هذه الحرية في العهد الجمهوري الجديد.
«إن موقف طه حسين لم يتجاوز هذا الدور المساير للضباط قط، مؤثراً السلامة، فأكثر من مثقف في هذا الوقت يذكر لي أن طه حسين ينقل هذا الموقف إلى كتّاب الجيل التالي له، ممن تسول له نفسه بمعارضة النظام بشكل عام.
وعلى سبيل المثال، فإنه يلوم عبد الرحمن الشرقاوي على موقفه المناهض للثورة أول قيامها قائلاً له قولة ظل يرددها كثيراً بعد ذلك، وهي: إن من أحمق الحمق أن تتحامق على حمقى».
هذا ما نقله مصطفى عبد الغني، في كتابه الثالث من محضر نقاش مع عبد الرحمن الشرقاوي بتاريخ: 25-2- 1985.
وردت في مقالة طه حسين الذي دافع فيه عن نفسه جملة قال فيها: «والناس جميعاً يعلمون أن الوزراء ما كانوا ليخطبوا أمام فاروق فيعيبوه ويذموه ويدلوا على ما كان يتورط فيه من طغيان وما كان يقترف من آثام... وإنما جرت عادة الوزراء حين يتحدثون إلى الملوك أن يتحدثوا بغير هذا».
جملة طه حسين تدعي أن بإمكان الوزراء في خطبهم أمام الرئيس في العهد الجمهوري الجديد «أن يتحدثوا بغير هذا». أي أن «يعيبوه ويذموه ويدلوا على ما كان يتورط فيه من طغيان وما كان يقترف من آثام»!
فـ«الحديث بغير هذا» قاصر على مخاطبة الملوك، ولا يشمل مخاطبة الرؤساء الجمهوريين!
وتلك مغالطة مكشوفة، يعرف هو زيفها. فقد لمس عن قرب النزعة الاستبدادية في تصرفات الضباط الأحرار ومسالكهم، التي كانت تستوجب من الوزراء ومن السياسيين المعارضين ومن المثقفين والصحافيين وسواهم «الحديث بنقيض هذا»، وليس فقط «الحديث بغير هذا».
المفارقة أنه قال جملته تلك في سياق دفاعه عن نفسه أمام اتهام وجه له في محاكم الثورة، واضطر أن ينشر دفاعه عن نفسه في أكثر من مطبوعة، (راجع كتاب مصطفى عبد الغني الثاني. وقد حدد رجاء النقاش في الجزء الثاني من مقاله في مجلة «الهلال» بأنها محكمة الشعب، حيث إنه كانت للثورة محكمتان هما: محكمة الثورة ومحكمة الشعب).
المفارقة الأخرى أن ذلك الاتهام وجه له مع أنه على رأس المثقفين الليبراليين المؤيدين للضباط الأحرار، وعلى رأس المجادلين للضباط الأحرار بأن ما قاموا به هو «ثورة» حقيقية وليس «حركة مباركة» ولا «انقلاباً» ولا «نهضة».
إن طه حسين قال بتلك الجملة، مع أنه يعلم «والناس جميعاً يعلمون» أن ما حصل له في محاكم الثورة لا يمكن أن يحصل ما هو أدنى منه بكثير له ولغيره في «العهد البائد»، وبتحقيب أطول «العصر البائد».
وهذان التعبيران من التعبيرات السياسية المستجدة في العهد الجمهوري الجديد التي كان طه حسين من بين مستعمليها.
ونحن نعلم أنه في العام الذي كتب رجاء النقاش مقاله «هل نحن على أبواب حرب أهلية في ميدان الفكر والثقافة؟!» عام 1979 كان مستقراً عند طوائف عدة في مصر وصم عهد جمال عبد الناصر بـ«العهد البائد»، فهل سيُدان ويجرّم من تلا آيات المديح لشخصه ولزعامته، ومنهم طه حسين، الذي استمر يتلوها إلى ساعة وفاته.
إن هذا المنحى في التفكير السياسي أدخلنا في دوامة مستمرة لم نستطع إلى الآن كسرها للخروج منها.
إن رجاء النقاش في الجزء الثاني من رده على كتاب أنور الجندي (طه حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام)، كان قد استعرض ما يعتقد أنها أخطاء سياسية ارتكبها طه حسين من عام 1906، عام دخوله إلى الحياة السياسية إلى عام 1933، عام انضمامه إلى حزب الوفد. هذه الأخطاء أجملها في انضمامه إلى أحزاب الأقلية، بدءاً من حزب الأمة، ثم حزب الأحرار الدستوريين الذي تمخض عن حزب الأمة وحل محله، ثم حزب الاتحاد ثم عودته إلى حزب الأحرار الدستوريين.
وكان قد استخدم مقال طه حسين المشار إليه آنفاً في الرد على اتهام أنور الجندي له بأن قبّل يد الملك فاروق عندما عين وزيراً للمعارف في عام 1950، وأنه قبل ذلك وبعده مدحه مدحاً شديداً في مناسبات متعددة.
السؤال: لماذا لم يستحضر ما اعتقد أنها أخطاء سياسية ارتكبها طه حسين إلى عام 1933 في مثال طه حسين الذي جعله موازياً لمثال محمد عبده؟!
الجواب: لأنه لم يجد من منظوره السياسي ما يبرر لطه حسين انضمامه إلى أحزاب الأقلية، ما وجده في مهادنة محمد عبده لكرومر وتعاونه معه، وهو أنه بصلته الوثقى بكرومر - كما قال - انطلق ليعمل في إصلاح الأزهر، وتطوير التعليم به، بحيث يتلاءم مع العصر. وساعده على التمهيد لإنشاء أول جامعة عربية، وهي جامعة القاهرة الآن. وساعده أيضاً على نشر حركة التنوير والإصلاح في الثقافة والمجتمع.
إن العيب لا يتوقف على الاختلال بين المثالين: مثال محمد عبده ومثال طه حسين، بل في الفكرة التي سماها «المواقف المؤقتة» والتي أقام عليها مثاليه.
فهذه الفكرة رجراجة ومطاطة، والفكرة الأكثر تحديداً في مثال محمد عبده، أنه وحزب الأمة وحزب الأحرار الدستوريين، وكذلك حزب الوفد، كانوا من مدرسة الواقعية السياسية في التعامل مع الاحتلال الإنجليزي. وكان يقابلهم وعلى الضد منهم في موقفهم من الاحتلال الإنجليزي، المنادون بالجامعة الإسلامية العثمانية والحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل الذين كانوا يدعون لمواجهته لا لمفاوضته.
والخطأ يمكنه في الأساس من وضع رجاء النقاش الاتهامات القاسية لطه حسين ومحمد عبده في إطار سياسي. فمحمد محمد حسين والذين ساروا على نهجه لم يوجهوها لهما ولغيرهما، لغاية سياسية، بسبب اتخاذ هذا أو ذاك «مواقف سياسية مؤقتة». فالتشنيع السياسي عليهم كان ذريعة من بين ذرائع كثيرة، تخدم غايتهم الأساسية، وهي رفض التحديث في غير الميادين التالية: الجيش، الصناعة، الاقتصاد، الإدارة. وهذا ما نص على قوله أستاذهم محمد محمد حسين. وللحديث بقية.
GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًاGMT 11:46 2025 الأحد ,26 كانون الثاني / يناير
الرئيس السيسى والتعليم!GMT 19:13 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير
أصالة ودريد فى «جوى أورد»!حاكم مصرف لبنان بتعهد بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده
بيروت - لبنان اليوم
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية ...المزيدكندة علوش تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي» مؤكدة أنه شكّل لها تحديًا كبيرًا بعد فترة توقف عن التمثيل
القاهرة - لبنان اليوم
تحدثت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي»، مؤكدة أن الدور شكّل لها تحديًا كبيرًا، خاصة بعد فترة توقف عن التمثيل. قالت كندة علوش خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء ال�...المزيدأمازون تسعى للاستحواذ على تيك توك في صفقة مثيرة للجدل
واشنطن - لبنان اليوم
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية (أمازون) قدمت عرضا لشراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، قبل ساعات من بدء حظر المنصة في ال...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©