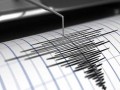الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
هل من حرب باردة جديدة؟
هل من حرب باردة جديدة؟

الدكتور ناصيف حتّي*
قمم غربية ثلاث، عُقدت في الأسبوع الأخير لشهر يونيو (حزيران)، طغت على جدول أعمالها بشكل خاص، أو شبه كلي، الأزمة الأوكرانية وكيفية التعاطي مع مختلف جوانبها، وكذلك تداعياتها القريبة والبعيدة. ولم يكن ذلك بالمفاجئ بسبب الأطراف الدولية المشاركة في الأزمة، وفي الحرب القائمة، بشكل مباشر، أو غير مباشر، وموقع هذه الأزمة في قلب المسرح الاستراتيجي الأوروبي، ذي الأهمية الخاصة بالنسبة للولايات المتحدة، ولروسيا الاتحادية، وكذلك للقوى الغربية الأوروبية، وتلك الحليفة لكل من الطرفين. القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، ناقشت مقترح إنشاء «جماعة سياسية أوروبية» أو أوروبا الواسعة، وهي فكرة ساهمت فرنسا بشكل خاص في بلورتها ولقيت ترحيباً واسعاً. لا يعني ذلك بالطبع إضعاف الاتحاد الأوروبي، لكن خلق إطار أشمل مفتوح للجميع في أوروبا، يساهم في تعزيز التعاون بأشكاله كافة في «البيت الأوروبي» الواسع، وبالأخص بين الاتحاد الأوروبي وجواره المباشر المؤثر والمتأثر به. ولكن التركيز في القمة الأوروبية كان على كيفية مواجهة الخطر الروسي، من خلال زيادة العقوبات على روسيا، والعمل على التخفيض التدريجي للاعتماد على الطاقة الروسية ومساعدة الدول النامية وتدعيم الأمن الغذائي في أفريقيا (إحدى مناطق الجوار الاستراتيجي الهام لأوروبا). القمة الأوروبية أيضاً وضعت كلاً من أوكرانيا ومولدوفا على لائحة «الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي». واعتبر ذلك موقفاً أوروبياً متقدماً لقبول هاتين الدولتين لاحقاً في الاتحاد الأوروبي، باعتبار أنهما استوفتا كثيراً من الشروط على درب الانضمام إلى البيت الأوروبي. في السياق ذاته، سياق التوسيع التدريجي للاتحاد الأوروبي وصيغة علاقات تعاون مع الدول الأوروبية الأخرى ضمن ما يعرف بمقاربة «الهندسة المتغيرة»، وكذلك مقاربة «السرعات المختلفة» للتعاون في البيت الأوروبي الواسع، جاءت القمة المشتركة مع دول غرب البلقان، لتعزز هذا الاتجاه. احتواء النفوذ الروسي كان العنوان الأساسي لهذه القمة، كما وصفه أحد كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
قمة «مجموعة السبع» التي استضافتها ألمانيا جاءت مكملة للقمة الأوروبية فيما يتعلق بتخفيض الاعتماد على الطاقة الروسية وتعزيز سياسة العقوبات على موسكو، وكذلك إطلاق برنامج طموح، في فترة تعاني فيها الاقتصادات كافة، ومنها المتقدمة، حالة من الركود التضخمي، تجاه الدول النامية التي بشكل خاص تتأثر من تداعيات الأزمتين؛ أزمة جائحة «كورونا» وأزمة أوكرانيا. أطلقت مجموعة السبع ما عرف بمشروع «البنية التحتية والاستثمار العالمي». ويهدف المشروع ذو الموازنة التي تصل إلى 600 مليار دولار، لفترة 5 سنوات، إلى إحداث مزيد من الترابط والاندماج والتعاون، خاصة مع الدول والأقاليم النامية على الصعيد العالمي. ويبقى السؤال قائماً حول القدرة على القيام بذلك، في خضم التكاليف المختلفة الناجمة عن تداعيات أزمة أوكرانيا المستمرة والمتصاعدة.
قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها إسبانيا اعتمدت ما عرف بـ«التوجه الاستراتيجي للمستقبل» للحلف من حيث تحديد تحديات جديدة أمام الحلف مثل الإرهاب والحروب السيبرانية، وكذلك التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة. وقد اعتبرت القمة، التي حضرتها للمرة الأولى اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أن روسيا تشكل أهم تحدٍ مباشر لأمن الحلفاء. ومن المفارقات أن مدريد استضافت قبل 25 عاماً، في مايو (أيار) 1997 لقاء بين الحلف الأطلسي وروسيا الاتحادية حيث تم التوصل إلى اتفاق تعاون بين الطرفين.
كما جرى التركيز في القمة على أن الصين الشعبية تمثل تحدياً كبيراً لمصالح وأمن وقيم الغرب. كما قررت القمة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وزيادة عدد القوات ضمن ما يعرف باستراتيجية الجهوزية للقتال في «المسرح الاستراتيجي» الأوروبي. وقد نجح الحلف الأطلسي في صياغة التفاهم المطلوب، لانضمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف، بين هاتين الدولتين وتركيا، العضو في الحلف، التي اشترطت لرفع الفيتو عن انضمام الدولتين تغيير «سياستهما الكردية»، التي قامت حسب أنقرة على احتضانهما ودعمهما لقوى كردية في حالة حرب مع تركيا. ويقول الأتراك إن العبرة تبقى في التنفيذ، ولو تم التوصل إلى الاتفاق.
ملاحظات خمس لا بد من التوقف عندها غداة القمم الثلاث...
أولاً؛ عودة الحيوية والنشاط لحلف شمال الأطلسي بعد أن تراجع دوره بعد غياب العدو الاستراتيجي الذي كان متمثلاً بالاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، ولو انضم إليه كثير من الدول التي كانت تدور في الجهة المناوئة. لكن غياب العدو الاستراتيجي ساهم في تراجع دور الحلف الأطلسي، وزادت في ذلك بشكل كبير الخلافات الأميركية الأوروبية حول نسبة المساهمة في الحلف. وازداد الخلاف بشكلٍ أكبر مع سياسة الرئيس ترمب القائمة على أحادية حادة على حساب الدبلوماسية المتعددة الأطراف. أزمة أوكرانيا أعادت الحياة بقوة إلى الحلف الأطلسي، وإلى أهمية توسيع عضويته وتعزيز دوره.
ثانياً؛ أزمة أوكرانيا وسياسة الإدارة الأميركية الحالية القائمة على الانخراط الجماعي مع الحلفاء وإعادة ترميم الحلف الغربي، خاصة ما يمكن أن تحمله الأزمة الحرب الأوكرانية من تداعيات تتخطى «الملعب» الأوكراني، أعادت دور القيادة الغربية إلى الولايات المتحدة، من دون أن يعني ذلك تكريسها كما كانت خلال الحرب الباردة لاختلاف الظروف والمعطيات.
ثالثاً؛ تراجع مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، بعد صراع بين الاتجاه الأطلسي والاتجاه الأوروبي في أوروبا، والصراع كان يعني الأولوية في تحديد السياسات والاستراتيجيات، وليس الطلاق. ودفعت الأزمة الأوكرانية لمصلحة الأولوية الأطلسية حالياً، دون أن يعني ذلك إغفال وجود اهتمام أوروبي بصياغة استراتيجية أوروبية مستقلة مستقبلاً «ومنسقة»، وليست بالضرورة متصادمة مع استراتيجية أطلسية.
رابعاً؛ هنالك رد فعل روسي طبيعي من خلال محاولة إحياء «حلف وارسو جديد». ويأتي تصريح وزير خارجية روسيا حول إقامة الغرب لستار حديدي جديد ليعبر عن العودة إلى سياسة الأحلاف. وتنشط روسيا ومعها بيلاروسيا بشكل خاص في تحريك دور «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» التي أنشأتها روسيا من دول ست، كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، لتكون بمثابة «حلف شرقي» يواجه الحلف الغربي.
خامساً؛ هنالك عودة كشفت عنها وكرّستها الأزمة الأوكرانية بتبلور مناخ حرب باردة جديدة، من حيث التحالفات والسلوكيات في خضم الأزمة القائمة. لا يعني ذلك بالضرورة الذهاب نحو «أحلاف مقفلة» لغياب العنصر الآيديولوجي، وكذلك الاستراتيجي الحاد، الذي قام من جهة، وكرس من جهة ثانية الثنائية القطبية التي طبعت نظام الحرب الباردة بالأمس.
نشهد اليوم تعزز منطق وخطاب الحرب الباردة، ولو بعناوين مختلفة. لكنها لن تكون، لتغير كثير من المعطيات، كما أشرنا إلى نسخة طبق الأصل عن الحرب الباردة التي قامت مع جدار برلين، دون أن يعني ذلك أنها لا تحمل كثيراً من المخاطر على الأمن والاستقرار الدوليين.
GMT 19:57 2025 الخميس ,20 شباط / فبراير
من «الست» إلى «بوب ديلان» كيف نروى الحكاية؟GMT 08:38 2025 الأحد ,09 شباط / فبراير
اختلاف الدرجة لا النوعGMT 19:29 2025 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
الكتب الأكثر مبيعًاGMT 11:46 2025 الأحد ,26 كانون الثاني / يناير
الرئيس السيسى والتعليم!GMT 19:13 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير
أصالة ودريد فى «جوى أورد»!رئيس الوزراء اللبناني يعتزم إعلان مشروع قانون مصرفي طال انتظاره
بيروت ـ لبنان اليوم
يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يعلن مساء الجمعة، عن مضمون مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، ويهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ الع�...المزيدماسك يقاضي شركة ناشئة لمحاولتها الاستحواذ على اسم تويتر وشعار الطائر الأزرق
واشنطن ـ لبنان اليوم
رفعت شركة «إكس كورب» المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد شركة ناشئة بسبب محاولتها الاستحواذ على اسم «تويتر» السابق وشعاره الشهير المتمثل في الطائر الأزرق. وكانت شركة «أوبريشن بلو بيرد&raqu...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©