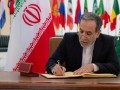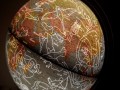الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
جريمة اغتيال الحوار الموضوعى!
جريمة اغتيال الحوار الموضوعى!

عماد الدين أديب
بقلم - عماد الدين أديب
حتى كتابة هذه السطور نحن - فى عالمنا العربى - لا نفهم، ولا ندرك، معايير التأييد أو النقد للحكم والحكومات.
لدينا مفهوم مؤلم، خاطئ، متوارث عن «المؤيد» و«المعارض»!
نرى المؤيد على أنه منافق، متزلف، باع نفسه لشيطان السلطة، وبريق مكاسبها.
نرى المعارض على أنه عميل، خائن، يتجنى كذباً على السلطة المعصومة عن أى خطأ!
الحقيقة ليس كل مؤيد منافقاً، وليس كل معارض خائناً!
والتعريف الموضوعى للحوار هو مراجعة الكلام والمنطق والمخاطبة والمراجعة.
والتعريف اللغوى للحوار هو الكلام المتبادل بين طرفين مع تقديم الأدلة المقنعة من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، وذُكرت كلمة حوار فى القرآن الكريم: «وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا».
وإذا كان خالق الأكوان، الله سبحانه وتعالى صاحب القوة المطلقة، مدبر كل شىء فى الحياة، قبل القبل وبعد البعد، قد سمح لإبليس أن يحاوره، فكيف يقوم الطغاة بقتل أو صلب أو تعذيب أو اعتقال من حاورهم برأى مخالف؟؟
من هنا الحوار وسيلة لا بديل عنها للتفاهم أو الاختلاف، ومن هنا يأتى الحق المطلق فى التأييد أو المعارضة.
وللحوار آداب وقواعد، أولها قاعدة جوهرية مبدئية لا بديل عنها، وهى أنه لا يوجد طرف واحد، كائناً من كان، يمتلك وحده دون سواه الصواب المطلق.
ومن آداب الحوار الإيمان الكامل بأن الاختلاف من سنن الحياة، لذلك لا يجب الاغتيال المعنوى لشخص أو فكرة من يخالفك الرأى.
من حقك أن تقول ما تريد، ومن حق غيرك أيضاً أن يؤيد أو يعارض ما قلت.
ويبقى السؤال الكبير: لماذا نتحاور؟ يقول جوزيف جوبرت: «الهدف من الحوار والجدال مع الآخرين ليس تحقيق النصر عليهم وهزيمتهم ولكن من أجل دفعنا إلى التقدم».
نفعل ذلك وننسى أن من يعارض الطرف ألف من موقع التأييد هو يعارضه، ومن يؤيد الطرف باء هو يعارض غيره!
السؤال الجوهرى الحاكم فى تقدير هذه المسألة هو: هل من يؤيد أو يعارض يبنى موقفه على «شخص» المسئول أم على «مضمون» قراره؟
بمعنى آخر: هل حينما أؤيد أرى أن فلاناً معصوم عن الخطأ، كفء، موفق، مبدع، مخلص فى كل ما يفعل؟ وهل حينما أعارض أرى أن فلاناً دائماً: مخطئ، مغرض، فاشل، مراوغ، مخادع، فاسد؟
إنها معضلة التقديس الدائم أو الشيطنة الأبدية للحاكم؟
نفعل ذلك ولدينا ازدواجية المعايير، ونعطى أنفسنا الامتياز الحصرى لتقديس من نحب وشيطنة من نكره!
أى مسئول منذ بدء ظهور أنظمة الحكم حتى قيام الساعة، فى أى زمان ومكان، يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً، ولا يوجد من خير مطلق أو شر مطلق، ففى البداية والنهاية صانع أى قرار هو إنسان، بشر، يُصدر قراره بناء على قيم معينة، ومبادئ مكتسبة ومصالح عامة، ودوافع خاصة كلها تتفاعل فى ظل معطيات موضوعية كى تكوّن قراره النهائى.
لذلك حينما نؤيد أو ننتقد علينا ألا نخجل من التأييد للمسئول إذا أصاب، ولا نخشى أن نصوِّب له القرار إذا أخطأ.
المؤيد على الدوام منافق، والمنتقد دائماً عدمى مخرب.
فى الحالتين، التقديس أو الشيطنة، يكون صاحب الرأى قد باع ضميره للشيطان!
الكراهية لبعض الحكام تنال ممن يؤيده، والتقديس للبعض الآخر ينال أيضاً ممن ينتقدهم!
ووسط هذه المهزلة الفكرية والأزمة الأخلاقية يصبح الجدل السياسى فى عالمنا العربى هو مسألة مصالح «مع» أو مصالح «ضد»، أى ثأر شخصى وثأر مضاد، ولا يدفع ثمن ذلك الجنون كله سوى الرأى العام.
ولأن غالبية أى رأى عام ليست من النخبة المثقفة المتعلمة العميقة الجذور التى تمتلك بوصلة سليمة لتقدير الأشخاص، والقرارات والمعايير، يصاب الناس بحالة من التشويش والارتباك والبلبلة.
أخطر ما يواجه أى رأى عام هو أن يفقد الثقة فى كل شىء، المؤيد والمعارض، الحاكم والمحكوم، ويضيع منه معيار الصواب والخطأ.
لذلك كله علينا أن ندفع فاتورة اغتيالنا المتعمد لمنهج الحوار الموضوعى!
يا للهول!
GMT 00:53 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير
فخامة الرئيس يكذّب فخامة الرئيسGMT 21:01 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر
بايدن والسياسة الخارجيةGMT 17:00 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر
أخبار عن الكويت ولبنان وسورية وفلسطينGMT 22:48 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
عن أي استقلال وجّه رئيس الجمهورية رسالته؟!!GMT 18:47 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب عدو نفسهحاكم مصرف لبنان بتعهد بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده
بيروت - لبنان اليوم
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية ...المزيدكندة علوش تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي» مؤكدة أنه شكّل لها تحديًا كبيرًا بعد فترة توقف عن التمثيل
القاهرة - لبنان اليوم
تحدثت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إخواتي»، مؤكدة أن الدور شكّل لها تحديًا كبيرًا، خاصة بعد فترة توقف عن التمثيل. قالت كندة علوش خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء ال�...المزيدأمازون تسعى للاستحواذ على تيك توك في صفقة مثيرة للجدل
واشنطن - لبنان اليوم
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية (أمازون) قدمت عرضا لشراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، قبل ساعات من بدء حظر المنصة في ال...المزيدفيلم عن فلسطين “لا أرض أخرى” لمخرج لفلسطيني و صحفي إسرائيلي يفوز ب" الأوسكار"
واشنطن - لبنان اليوم
توج فيلم “لا أرض أخرى” للمخرج الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، الإثنين، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السابعة والتسعين. وتسلم الجائزة في مسرح دول...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©